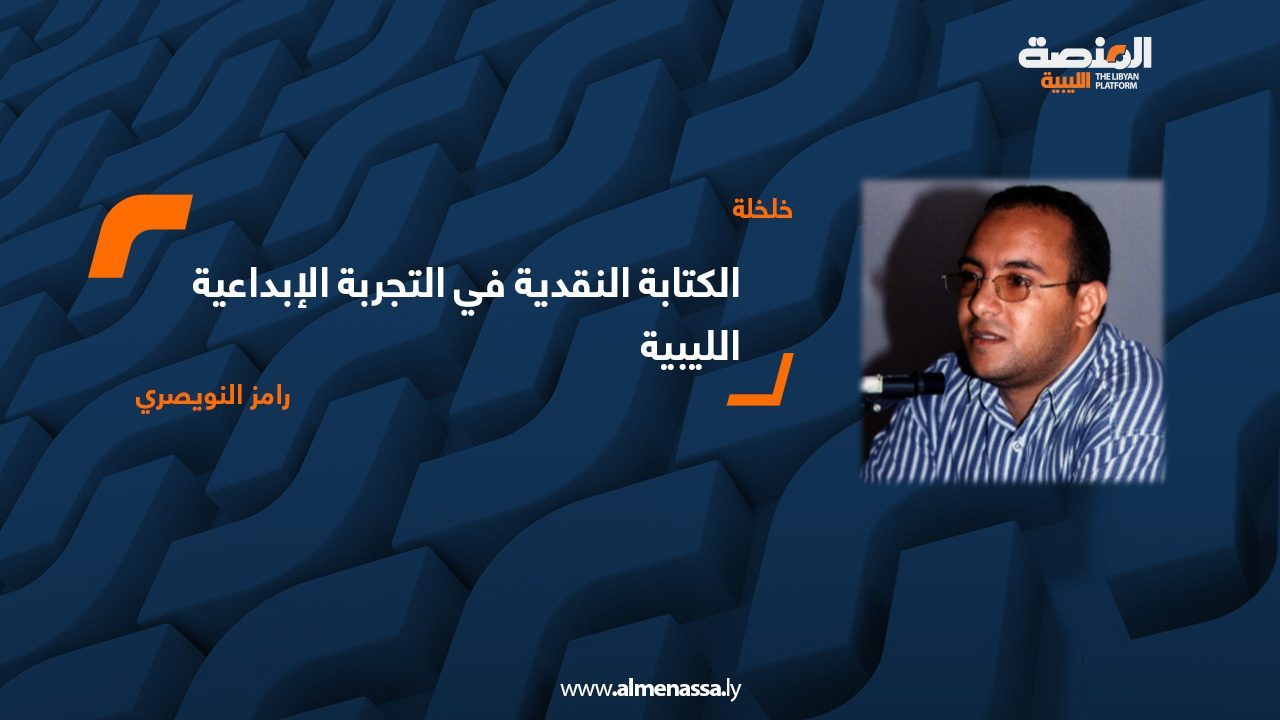الجزء الأول
رامز النويصري
كتب الأديب رامز النويصري مقالته في العشرية الأولى من الألفينيات فهل اختلف الحال ياترى حول النّقـد والنّـقـاد .. إذ كانت قراءة في واقع الكتابة النقدية في التجربة الإبداعية الليبية وقد اعترف أنه في مأزق إذ وضع نفسه في دائرة غير محددة المعالم بل وملبدة أجواؤها .. هل صفت الأجواء في 2025 م .. وكيف رآها بقراءة الناقد المتعايش لحالة الأدب في ليبيا ؟
على جزئين سنقرأها معا مضطلعين بإمعان على دراسة مهمة جاد بها للمكتبة الثقافية النقدية شاعر ومدون وكاتب يعول على النقد الأدبي لتصحيح مسار الآداب بمشاربها في بلادنا .
—-
لو اعتبرنا أن منتصف الخمسينيات من القرن الماضي هي بداية حالة استقرار المجتمع الليبي بعد رحلة طويلة من العذاب والشقاء ، كان نتاجها صدور أول مجموعة قصصية ( نفوس حائرة – عبد القادر أبو هروس 1957)، وأيضاً أولى مجموعات الشعر الحديث (الحنين الظامئ – علي الرقيعي 1957)، كما شهدت الخمسينيات أهم أسئلة النقد الليبي علي صعيدي الشعر والقصة :
** سؤال الشعر (هل لدينا شعراء) ؟! للكاتب خليفة التليسي .
** سؤال القصة (قصتنا بنت حرام) ؟! للكاتب كامل المقهور .
قد أربك القارئ بسردي لهذه الحقائق، ولكنني وجدت نفسي أستدعيها للتدليل علي أثر الاستقرار ونستطيع القول بأنه حتي اللحظة لم يتبلور مشروع نقدي ليبي ، لا في شكل مشروع عام (طرح فكري/ تنظيري) أو في مشروع خاص (ممارس حقيقي للعمل النقدي).
والسؤال المنطقي الذي يفرض نفسه : لماذا ؟
لنقف عند علامة الاستفهام دون حراك ، إذ الأهم هو الحصول علي الإجابة لتخطي انحناءة علامة الاستفهام الداخلية الإجابة الصعبة المفقودة حتي اللحظة والتي في وجودها تتغير الكثير من الأشياء، وربما أمكننا إعادة قراءة المنتج الإبداعي ، والإمساك بثيمات النص ، وإنتاج هذه الحقائق في متن مستقل قادر علي كشف النص ومرجعياته .
يقول الكاتب أحمد الفيتوري في إجابته عن سؤال النقد الليبي :
(…، فالكثيرون يسِمون التجربة الإبداعية الليبية بعدم وجود شغل نقدي، وإن كنت أري أن هناك عملاً نقدياً، إلا أنه من الضمور، بسبب ما يخص التركيبة السياسية والاجتماعية التي تحاول تأكيد السائد ، وإقصاء أي محاولة لتقديم فكر نقدي مغاير) .. وفي الختام يقول ( إبراهيم الكوني .. يلخص هذه العملية بشكل مؤيد ومدهش ومكثف .. وهو يشير إلي تراجع النقد عن تناول كتابات الروائي الليبي إبراهيم الكوني ، إلا من بعض الدراسات والبحوث الجامعية (أكاديمية) التي شهدتها السنوات الأخيرة) .
ستكون الإجابة من خلال مناقشة بعض النقاط :
أولا : فقد التراكم المعرفي والثقافي.ونعني بالتراكم المعرفي والثقافي كل ما يتعلق بالمعرفة والثقافة العربية من إنتاجٍ وتداول، إذ تثبت الحقائق أن العمق المعرفي والثقافي في ليبيا عمق ليس بالبعيد، وانه كان يخضع للواقع المفروض علي ليبيا5، فكلما تكونت في ليبيا مظاهر للعمران والنهضة الثقافية تعرضت البلاد لما يعيدها لمرحلة الصفر.ففي اللحظة التي عرفت فيها البلاد دخول المطابع وصدور الصحف بشكلٍ دوري (من هذه الصحف، طرابلس غرب /1866)6، وصدور أول ديوان شعري ليبي (عظة النفس/ مصطفي بن زكري /1892)، وتحقق في البلاد نوعٍ من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، جاء الغزو الإيطالي ليقود كل ما كان ويعود بالبلاد إلي النقطة الصفر، بالتالي حرم المجتمع من فرصة النهضة الثقافية، ليستمر هذا حتي خمسينيات القرن الماضي، وبالتالي كان لزاماً علي الثقافة الليبية أن تعيد جمع نفسها من جديد. وما تبقي من هذا التراث العربي هو:
1ـ مجموعة الكتب المحفوظة في الخزانات ، وهي في الغالب خاصة ، وبالتالي تظل معرفة خاصة بفرد.
2- كتب التراث الديني ، وكانت تتداول في الزوايا والمدارس الدينية .. وهو تراث غير قادر علي إنتاج معرفة عامة ، مما انعكس سلباً علي المجتمع فتأكدت الثقافة الشعبية (الشعر الشعبي بشكلٍ خاص)، والنقل الشفهي (المرويات الشفهية) ، إذ حال الوضع البائس للمواطن الليبي من نيل حقه في التعليم الذي اقتصر علي أهل المدن الخاضعة للاحتلال (ليس بشكلٍ كبير) ، الأمر الذي أوجد فيما بعد فجوة بين المواطن المثقف/ المتعلم (الحائز علي قسط من التعليم) والمواطن العادي ، ويمكننا القول أن المثقف انعزل في مرحلة قادمة وأنه مارس ثقافته بمعزل عن المجتمع ، هذا الأثر استمر حتي لحظتنا هذه .
ولعلنا نلمح هنا لسؤال التليسي الكبير (هل لدينا شعراء؟) إذ ألمح الأستاذ والكاتب خليفة التليسي لهذا الفـقر الثقافي وأثره في الشعر الذي توقف عند أغراض المدح والرثاء والمناسبات، حتي انه أشار لفقر الطبيعة لغلبة الصحراء على المشهد، وهو يصف المشهد الشعري في ليبيا بكل تجرد ووضوح حتي يصف من يمارسون الشعر بـ(التشاعر) كونهم يتطفلون علي الشعر دون مرجعية تؤهلهم امتلاك أدواتهم القادرة علي تجاوز اللحظة، والقبض علي أثرها، وكذا النمو الروحي والفلسفي لإعادة النظر في الحياة.
ثانيا : طبيعة التلميذ .. وهي نتيجة طبيعية لفقد المرجعية أو التراكم المعرفي القادر علي رفد التجربة الشخصية، لذا كان من الطبيعي البحث خارج الدائرة المحلية عن مثال يمكن الإفادة منه، فكان المشرق (الأستاذ العظيم) ، الأستاذ القادر علي إشباع رغبة المعرفة ، وسد الثغرة المعرفية .. ونعترف أن هذا الأستاذ قدم الكثير لتجربتنا الإبداعية في ليبيا .. ولقد أثر هذا الشرق بشكل كبير في التجارب الإبداعية ، وكذا الحوار الثقافي الذي كان صديً لما يناقش من قضايا في المشرق، ولقد رصد هذا الأثر أكثر من كاتب ، فها هو القاص والكاتب كامل المقهور يختصر القضية في عنوانه (قصتنا بنت حرام)، وعندما يشارك التليسي كتابة مقدمة ديوان (الحنين الظامئ) للشاعر علي الرقيعي يقول : (ومع انعدام الماضي الثقافي اللصيق بالشعب إذ استثنينا الأجزال الشعبية وبعض الأغاني، ومع افتقاد جماهيرنا الشعبية لمن يعبر عن انتفاضاتها ووعيها النفسي الجديد، اتجه المتعلمون إلي الثقافات الشرقية التي ابتدأت ترد إليها بعد الاستقلال من مصر ولبنان بالذات… ( ويضيف ) ….. وكان لا بد أن تتعثر الثقافة الجديدة وهي تستمد خطوطها العريضة مقلدة ثقافات وحركات لها ماض، وكان لا بد أن تتعثر هذه الثقافة فتنحرف أحياناً نتيجة استيراد مبادئ خاطئة، أو مبادئ ومفاهيم لا تستقيم وواقعنا الحياتي …) كما ورصد هذا الأثر بشكلٍ مبكر الكاتب الراحل سليمان كشلاف في أكثر من موضوع، فهو مثلاً يعلق علي رواية (نافذة علي المطل الخلفي)، لكاتبها محمد سالم عجينة ـ رحمه الله .. بقوله (سيبرز لنا تأثير بدايات الرواية العربية في مصر، علي محمد سالم عجينة ، متمثلة في (الأيام) الرواية/السيرة الشخصية للأديب العظيم طه حسين ، وليتأكد لنا أكثر خسارتنا لمشروع روائي جيد كان له أن يستمر ويتطور، لولا أن وافاه الأجل) .
ثالثا ـ فردانية التجربة.وربما كما قلتها ذات مرة (طابع الفردانية في التجربة الليبية)، وأقصد بها طابع الفردانية (من الفرد) الذي صبغ التجربة، حيث لم تعرف التجربة الليبية أياً من أشكال الجماعات الأدبية أو الثقافية، لا في شكل مجموعات أو مدارس ولا اتجاهات. هذا الطابع (صنو التجربة الليبية) هو نتاج طبيعي للتلمذة، فأنت لن تستطيع أن تفرض علي التلاميذ أن يكونوا نسخة عن أستاذهم، ولا أن يكون مستوي تلقيهم أو انتباههم واحداً، وبالتالي: (ليس من الشرط أن يجمعهم مستوي إدراكٍ معين (وهذا طبيعي)، ولا اتجاه واحد.. فالتجاور لا يعني وحدة التلاميذ تحت مسمي الفصل أو التلاميذ لهذا الفصل، فهذا الفصل مقسم إلي مقاعد يستقل بها التلاميذ، باتجاههم إلي الأستاذ ذاته.. ولعلنا نلاحظ بوضوح طبع العمل الفردي في الثقافة والأدب في ليبيا، بمعني أن الأمر ينسحب علي كل مجالات الإبداع، كلٌّ مستقل بنفسه عن التوجه والاتحاد.. فنري من يعمل كمؤسسة، ومن يعمل كموسوعة، ومن، ومن.. هذا الطبع عطل الكثير من المشاريع التي نسمع عنها ولا نراها، ونري الجزء منها دون الاكتمال، ونري المؤسسات الثقافية تـقـف وتتعطل في أشخاص.. وهذا جزء الشخصية الليبية، المتمثلة في الذات منفردة (ذاتها كشخص)، البعيدة عن قبول التوجه خارج نطاق وحدتها الصغيرة أو مجتمعها الكفيل (القبيلة)، الذي يتحول بهذه الذوات المنفردة ذاتاً منفردة) .
رابعا ـ الوضع الاجتماعي والسياسي .. نظراً لما عانته البلاد من اضطهاد، إذ بالقليل من الملاحظة ندرك أن ليبيا لم تعرف الاستقرار ـ كما أشرنا سابقاً ـ إلا من بداية الخمسينيات، وهو استقرار عرفت فيه البلاد الكثير من الحركات الجماعية بحثاً عن الاستقرار والعيش الهانئ11، لتأتي ثورة الفاتح في 1969 محققة الاستقرار للبلاد، وبحسبة سريعة ندرك أن تاريخ ليبيا الحديث يتعدي نصف القرن قليلاً (بمعني أن العمق التاريخي قريب)، هذه الطبيعة التي تكونت بها المدن أو المجتمعات المدنية أوجدت نوعاً من الانصراف عن الآخر (وهو الانصراف بالذات ـ كفرد ـ لتوفير هذه المتطلبات، وتحقيقها) .. بالتالي لم تـنـشأ في المجتمع ما يعرف بثقافة الحوار، والتي تعني التواطؤ الحادث بين طرفي الحوار بحيث يقبل كل طرف الآخر دون تجيـيرٍ للمواقف أو التعصب أو نبذٍ لرأي، باختصار ما نعني به قبول الآخر كشريك دون الاستقلال بالرأي والتعصب له .. فالعقلية الليبية لا تحاور وتعمل على تأكيد السائد ، وتستنكر كل ما عداه، وهي عقلية تحكم الحياة الليبية متسربة في كل مجالاته الحياتية والعملية، ويمكننا قراءة هذا الانحياز الأرضي في هذا التعبير المستخدم كثيراً في مجموعات العمل (ما تمس شي، ما يطرأ شي)، والمعني: (أنك ما لم تتدخل في سير العمل بشيء، فلن يحدث طارئ أو شيء). ولا يعني هذا انتـفاء النقد عن التجربة الإبداعية في ليبيا، بل العكس، فثمة أكثر من جهد نقدي يشاد به، لكن ما نعنيه هو الحضور الفعلي للنقد في التجربة الإبداعية، النقد بصفته اشتغال يرافق الإبداع ويدعمه (لا يخدمه كما يصف البعض)، إذ سيرقي النقد بالعمل الإبداعي ويرصد مفاتيحه، ويقف علي مناطقه الحارة، وبذلك يكون النقد إبداعاً موازياً. ذات أمسية شتائية ماطرة، دار نقاش حول ما كتبته عن تجربة شعر المحكية، إذ علق الشاعر محمد الدنقلي أنه رغم الجهد الواضح والمميز لهذا البحث، إلا أنه كان من الواجب البحث أكثر في خصوصية التجربة الشعرية، أو الدخول لتجربة شعر المحكية من الخلف، وجدت نفسي أعلق: (لا تنس أستاذ محمد أنا لست بناقد، وعادة ما أعنون ما أكتبه بـ(قراءة)، أخذنا الحديث عن النقد، فأعلق: (ألا تلاحظون معي أن تجاربنا النقدية في ليبيا لم يكتبها نقاد متخصصون، إنما كتبت من قبل ممارسين للنص الإبداعي).
هذه حقيقة .. إذ يكشف تاريخ النقد في ليبيا (رغم قصره)، أن الممارسة النقدية كانت لشعراء وقصاصين دخلوا هذا المجال، أو مارسوا العمل علي النصوص بعد أن وقعت في نفوسهمفنذكر:
- خليفة التليسي ـ شاعر
- كامل المقهور ـ قاص
- علي مصطفي المصراتي ـ قاص
- سليمان كشلاف ـ قاص
- خالد زغبية ـ شاعر
- مفتاح العماري ـ شاعر
- محمد الفقيه صالح ـ شاعر
- سالم العوكلي ـ شاعر
- أحمد الفيتوري ـ مسرح ، رواية
- منصور بوشناف ـ مسرح
- إدريس المسماري ـ شاعر
- حسين نصيب المالكي ـ قاص
- زياد علي ـ قاص
- منصور العجالي ـ شاعر
- نادرة عويتي ـ قاصة
- حواء القمودي ـ شاعرة
- سميرة البوزيدي ـ شاعرة
نلاحظ أن الغالبية المذكورة من الشعراء ، هذه القراءات إذن تميزت بالتالي :
1ـ خضوع هذه القراءات للذائقة الشخصية، بمعني أنها تتفاوت من متنٍ إلي آخر، بالدرجة التي وقع فيها النص من نفس القارئ/المتلقي (ففي النهاية هي لحظة تلقي النص)، هذا بالتالي يشير إلى : الانطباعية التي تمارس بها الكتابة // الرصيد المعرفي للدخول للنص // وأيضاً القادر على ترجمة الانطباع إلى وحدات لغوية راصدة.
2 ـ الاتكاء علي عناوين تجنيسية من قبيل (قراءة) للهروب من مأزق الكتابة النقدية (المتخصصة)، فالممارس لهذا العمل يدرك أنه لا يجيد العمل النقدي المحترف.
3 ـ خلو هذه الكتابات من منهج نقدي يحكمها، بمعني أن هذه الكتابات تخضع لترتيب الممارس لا ضرورات المنهج، لذا لم يكن من السهل أن يتم تبني منهج نقدي محدد، إنما تحدد العمل لما تمكنه الحصيلة المعرفية للكاتب.لكن نلاحظ أنه ثمة من انتصر فيه العمل النقدي علي عمله الإبداعي، فصار يعرف كناقد أكثر منه ممارساً للعمل الإبداعي، فأخذ العمل النقدي الأستاذ سليمان كشلاف بعيداً عن القصة، وكذا الأستاذ أحمد الفيتوري الذي تفرغ للنقد بعد تجربة مع الكتابة المسرحية. كما وكتبت في النقد بعض الأسماء التي لم تتميز أو لم تختص بكتابة جنس إبداعي معين، وإن أبدعت في جنس، كـ:صادق النيهوم/ نجم الدين غالب الكيب/ أمين مازن/ د. الصيد أبو ديب/ نورالدين الماقني/ فوزي البشتي.ولقد شهدت أواخر التسعينيات عملاً نقدياً مميزاً في مجموعة من الأسماء النقدية الممارسة للعمل النقدي بشكلٍ محترف، وهم مجموعة رأت في النقد نصاً موازياً للنص الإبداعي، فقدمت هذه الأسماء مجموعة من الكتابات النقدية المهمة، والتي تميزت
ـ اعتماد هذه الكتابات علي منهج نقدي محدد في تنظيره، ولقد اعتمدت هذه الكتابات علي التنظيرات الحديثة للنص.
ـ الانحياز للنص، وهي غاية تخدم التنظير.
ـ العمل بشكل أكثر حرفية، ناحية تفكيك وحدات النص، والعمل علي الأجزاء .
من هذه الأسماء نذكر: محمد المالكي / محمد الترهوني/ عبد الحكيم المالكي .. وما يلاحظ علي الكتابات النقدية الحديثة في ليبيا (نعني الألفية الجديدة)، أنها كتابات لا تتعلق بالنص فقط، إنما تناولت الكثير من الموضوعات الخارجة عن الإبداع في محاولة منها لمناقشة الفكر، والأطروحات الفكرية للمجتمع والدولة ، وهنا نذكر كتابات الناقد أحمد الفيتوري ، و الناقد الشاب عز الدين اللواج .